مقالات
“مشروع اللغة الإنقاذية: الفاعلية الحضارية لها” زيد الأعظمي – الإمارات
جوهر النظرية "اللغة لسيت مجرد أداة للتغيير ، بل هب المخندس الخفي للواقع الإنساني

تشخيص الوهن الحضاري عبر اللغة
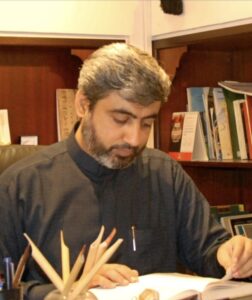
نعيشُ اليومَ في خضمِّ أزمةٍ حضاريةٍ مُركَّبةٍ، تتجلى في تشظي القيم، وتفككِ الروابطِ الاجتماعية، واغترابِ الإنسانِ عن ذاتهِ وكونهِ. إنَّ محاولةَ فهمِ هذهِ الأزمةِ من خلالِ مظاهرها الاقتصاديةِ أو السياسيةِ فقط، هيَ أشبهُ بِمُعالجةِ أعراضِ المرضِ دونَ الوصولِ إلى جذورهِ الحقيقية. إنَّ الفرضيةَ الأساسيةَ لهذا الموضوع هو: أنَّ كلَّ تحولٍ حضاريٍ حقيقيٍ يبدأُ بثورةٍ لسانيةٍ، وأنَّ الأزمةَ المعاصرةَ في جوهرها هيَ أزمةٌ لسانيةٌ بامتياز: لغاتٌ مريضةٌ تُنتجُ وعيًا مريضًا، ووعيٌ مريضٌ يُنتجُ حضارةً مريضة.
تَطرحُ هذهِ المقالةُ رؤيةً مُبتكرةً، تؤسسُ لـ “نظريةِ الفاعليةِ الحضاريةِ للغة“، والتي تعتبرُ اللغةَ “الشفرة الأساسيَّ” الذي يُبرمجُ الوعيَ الإنسانيَّ. تُشخِّصُ المقالةُ أعراضَ المرضِ اللسانيِّ المُعاصرِ، وتستعرضُ آثارَهُ المدمرةَ على الفردِ والمجتمعِ والحضارةِ، لتصلَ في النهايةِ إلى طرحِ مشروعٍ إنقاذيٍّ “اللغة العالمية الإنقاذية“ وهيَ ليستْ مجردَ لغةٍ جديدةٍ، بلْ هيَ نظامٌ لسانيٌّ يحملُ في بنيتهِ الشفرةَ الجينيةَ لِحَضارةٍ سليمةٍ، وقادرٌ على إعادةِ برمجةِ الوعيِ الإنسانيِّ ليكونَ قادراً على إدراكِ الحقائقِ، وبناءِ العلاقاتِ، وإنتاجِ الحلولِ الإبداعيةِ، وتحقيقِ التوازنِ الكونيِّ.
التأسيس النظري – اللغة كفاعل حضاري
ثورة في فهم اللغة – من الأداة إلى الهندسة والتشكيل
1- النظرية التقليدية وحدودها
لقد هيمنَ على الفكرِ الإنسانيِّ لفتراتٍ طويلةٍ فهمٌ سطحيٌّ للغةِ، يختزلُها في كونها “مرآةً محايدةً” تعكسُ أفكارَنا ومشاعرَنا. هذا الفهمُ التجزيئيُّ، الذي يُفرِّقُ بينَ الشكلِ والمضمونِ، وبينَ اللغةِ والواقعِ، هوَ المسؤولُ عن تجاهلِ القوةِ التكوينيةِ والفاعليةِ الحضاريةِ للغة. من منظورِ علمِ النفسِ المعرفيِّ، فإنَّ هذا الفهمَ قدْ أدى إلى إهمالِ الكيفيةِ التي تُبنى بها خرائطُنا الذهنيةُ من خلالِ الألفاظ، وكيفَ أنَّ الكلماتِ التي نستخدمُها تُحددُ الحدودَ التي يستطيعُ عقلُنا التفكيرَ ضمنَها. لقدْ غفلَ هذا الفهمُ عنِ البعدِ الأعمقِ الذي يُشيرُ إليهِ الفيلسوفُ فيتغنشتاين في مقولتهِ: “حدودُ لغتي هيَ حدودُ عالمي ” مُسلِّطاً الضوءَ على أنَّ ما لا يمكنُ أنْ يُقالَ، لا يمكنُ أنْ يُفكَّرَ فيه”ِ.
2- الفهم الثوري الجديد: اللغة كمهندس للواقع
تطرحُ نظريةُ “الفاعليةِ الحضاريةِ للغة” فهمًا ثوريًا، مفادهُ أنَّ اللغةَ ليستْ مجردَ “أداةِ وصفٍ” بل هيَ “تقنيةُ خلق”. إنَّ كلَّ كلمةٍ ننطقُها ليستْ مجردَ صوتٍ، بل هيَ بذرةٌ فكريةٌ تُساهمُ في تشكيلِ الواقعِ على مستوياتهِ الأربع:
-
الواقع المعرفي: من خلالِ الآليةِ المعرفيةِ التي تُبنى بها مفاهيمُنا وتصوراتُنا عنِ العالم.
-
الواقع النفسي: من خلالِ الآليةِ العاطفيةِ التي تُثيرُ فينا مشاعرَ معينةً، فالكلماتُ التي نستخدمُها لوصفِ ذواتِنا تُعيدُ برمجةَ هويتنا النفسية.
-
الواقع الاجتماعي: من خلالِ الآليةِ السلوكيةِ التي تُحددُ قواعدَ التفاعلِ والعلاقاتِ بينَ الأفرادِ.
-
الواقع الوجودي: من خلالِ الآليةِ الروحيةِ التي تُحددُ طبيعةَ علاقتنا معَ المقدسِ والمطلقِ، وتُشكِّلُ رؤيتَنا الكونية.
إنَّ هذا الفهمَ الجديدَ يُعيدُ الاعتبارَ للغةِ كقوةٍ تكوينيةٍ، ويُلفتُ النظرَ إلى أنَّ الأزمةَ الحضاريةَ هيَ في حقيقتها انهيارٌ في هذهِ القوةِ، وتفككٌ في الآلياتِ التي تُشكِّلُ بها اللغةُ الواقعَ.
3- أمثلة تاريخية على القوة التحويلية للغة
التاريخُ شاهدٌ على هذهِ الفاعليةِ الحضاريةِ للغة، فكلُّ نقطةِ تحولٍ كبرى في تاريخِ البشريةِ ارتبطتْ بزلزالٍ لسانيٍّ:
-
الثورة القرآنية: لقدْ أحدثتِ اللغةُ القرآنيةُ ثورةً غيرَ مسبوقةٍ، لا لِجمالِها اللغويِّ فقط، بل لِقدرتها على إعادةِ برمجةِ الوعيِ العربيِّ. لقدْ أعادتْ تعريفَ المفاهيمِ الأساسيةِ كالوجودِ، والحياةِ، والموتِ، والغاية (كما ذكر الدكتور فضل عباس في كتابه “خصائص التراكيب والدلالات في القرآن الكريم”، لقدْ حولتْ كثير من الكلمات إلى مفهومٍ يربطُ الإنسانَ بمسؤوليتهِ تجاهَ الكونِ، وأعادتْ تعريفَ “العملِ” كعبادةٍ. إنَّ هذهِ اللغةَ ليستْ مُجردَ شعرٍ أو نثرٍ، بلْ هيَ نظامٌ كونيٌّ أعادَ تشكيلَ واقعِ أمةٍ بأكملها.
-
النهضة الأوروبية: لمْ تبدأِ النهضةُ الأوروبيةُ بالصناعةِ أو التجارةِ، بلْ بدأتْ بإحياءِ اللغاتِ الكلاسيكيةِ (اللاتينيةِ واليونانيةِ) وتطويرِ لغاتٍ وطنيةٍ جديدةٍ للعلمِ والفلسفةِ. لقدْ أتاحتْ هذهِ اللغاتُ الجديدةُ فضاءً فكريًا لمْ يكنْ متاحاً من قبلُ، وخلقتْ مفاهيمَ لمْ تكنْ موجودةً في العصورِ الوسطى، مما مهدَ الطريقَ لِعصرِ التنويرِ والثورةِ العلميةِ. وهنالك مسالة في غاية الأهمية في أهمية اللغة الأم وهو أن الذين غيروا وجه أوربا لم يكن الطلبة الآلاف الذين كانوا يُبتعثون من أوربا إلى جامعات غرناطة وبيت الحكمة في بغداد، بل كانوا ممن أخذوا العلوم العربية بعد أن ترجمت إلى لغاتهم الأم.
-
التحولات الحديثة: تُظهرُ التحولات الاجتماعية والثقافية والفكرية كيفَ أنَّ اللغةَ هيَ السلاحُ الأقوى في تغييرِ الوعي. من: “البروليتاريا” و”الرأسماليةِ” في الخطابِ الماركسيِّ، إلى “العرقِ النقيِّ” في الخطابِ النازيِّ، كانتِ الكلماتُ هيَ اللبناتُ التي بُنيتْ بها عوالمُ فكريةٌ جديدةٌ، قادرةٌ على تعبئةِ الجماهيرِ وتوجيهِها.
اللغة كأداة لإعادة تشكيل النظام الأخلاقي العالمي – آلية التأثير الأخلاقي للغة
1- كيف تصنع اللغة الأخلاق؟
إنَّ اللغةَ ليستْ مُجردَ أداةٍ لِوصفِ الخيرِ والشرِّ، بلْ هيَ آليةٌ حيويةٌ لِصناعةِ الأخلاقِ وبرمجةِ الضمير.
-
تشكيل المفاهيم الأخلاقية: تُحددُ اللغةُ ما نعتبرهُ “خيرًا” أو “شرًا” من خلالِ الكلماتِ المتاحةِ لوصفهِ. ففي الثقافاتِ التي تُعلي من شأنِ “المروءةِ”، تُصبحُ هذهِ الكلمةُ محورًا أخلاقيًا يوجهُ السلوك. يقولُ الفيلسوفُ ماكس مولر: “الكلمةُ تُجبرُنا على التفكيرِ بطريقةٍ معينةٍ”. إنَّ اللغةَ تُرتبُ الأولوياتِ الأخلاقيةَ، وتخلقُ روابطَ معنويةً بينَ المفاهيم. على سبيلِ المثالِ، في الخطابِ الحضاريِّ العربيِّ التقليديِّ، كانتْ كلمةُ “الكرمِ” مرتبطةً بـ”الشرفِ” و”الكرامةِ”، مما أدى إلى بناءِ نظامٍ قيميٍّ يُعلي من شأنِ العطاءِ. بينما في اللغةِ الماديةِ المعاصرةِ، ربما قدْ يوصفُ الكرمُ بـ”السذاجةِ” أو “عدمِ الكفاءةِ الاقتصاديةِ”.
-
برمجة الضمير: تعملُ اللغةُ كـ”مبرمجٍ للضمير” من خلالِ التكرارِ اللاواعيِ للألفاظِ. فالكلماتُ التي نسمعُها ونقولُها يوميًا تُشكِّلُ ضميرَنا تدريجيًا. اللغةُ الإعلانيةُ اليومَ، على سبيلِ المثالِ، تُعيدُ برمجةَ ضميرِنا لِيُعطيَ الأولويةَ للاستهلاكِ والمادةِ ولربما يكون ذلك في بعض الأحيان على حسابِ القيمِ الروحيةِ والأخلاقيةِ.
2- نماذج تاريخية لإعادة التشكيل الأخلاقي عبر اللغة
لقدْ أثبتَ التاريخُ أنَّ إعادةَ التشكيلِ الأخلاقيِّ تبدأُ دائمًا بلغةٍ جديدةٍ. النموذجُ القرآنيُّ خيرُ شاهدٍ على ذلكَ، حيثُ أعادَ تعريفَ مفاهيمَ مثلَ “الجاهليةِ” و”الإسلامِ”، وخلقَ معجمًا أخلاقيًا جديدًا (كالتقوى والإحسان). في المقابل، تُظهرُ النماذجُ السلبيةُ، مثلَ اللغةِ الطائفية أو العرقية كالنازيةِ وغيرها، إذن يمكنُ للغةِ أنْ تُبرمجَ الضميرَ البشريَّ لِيُصبحَ قادرًا على قبولِ أبشعِ الجرائمِ. إنَّ هذهِ النماذجَ تُؤكدُ أنَّ المعركةَ الأخلاقيةَ هيَ في جوهرها معركةٌ لسانيةٌ.
3- التصنيفُ اللغويُّ: تأطير الواقعِ الاجتماعيِّ
تمنحنا اللغةُ القدرةَ على تصنيفِ العالمِ وتسميتهِ وتاطيره. فعندما تتشكل المصطلحاتٍ الجديدةً، فإنها لا تصفُ واقعاً موجوداً فحسب، بل تخلقُ واقعاً جديداً من خلالِ:
-
خلقُ هوياتٍ جماعيةٍ: في الخطابِ الماركسيِّ، لمْ تكنْ كلمةُ “البروليتاريا“ مجردَ وصفٍ للطبقةِ العاملةِ، بلْ كانتْ تسميةً جديدةً خلقتْ هويةً جماعيةً مشتركةً. هذهِ الكلمةُ جمعتْ أفراداً متفرقينَ تحتَ مظلةٍ واحدةٍ، ومنحتهمْ إحساساً بالوحدةِ والهدفِ المشتركِ. بالمثلِ، فإنَّ مصطلحَ “العرقِ النقيِّ“ في الخطابِ النازيِّ لمْ يكنْ مجردَ تصنيفٍ بيولوجيٍّ، بل كانَ أداةً لخلقِ هويةٍ متعاليةٍ، تؤمنُ بتفوقها على الأعراقِ الأخرى.
-
صناعةُ “الآخرِ” المُعادي: يُعدُّ التصنيفُ اللغويُّ أداةً قد تعمل على تحديدِ المخالف. فعلى سبيل المثال: بعض النظم الاقتصادية لمْ تصفْ نظاماً اقتصادياً فحسبُ، بلْ جسَّدَته عدوَا يجبُ محاربتهُ. بالمثلِ، فإنَّ مصطلحَ “الآخرِ“ (الذي يمثل أحياناً ديناً أو طائفة أو عرقاً) في خطابِ معين، كانَ يمثل تسميةً تجرِّدُ الإنسانَ منْ إنسانيتهِ، وتبرِّرُ العنفَ ضدهُ، وتسهِّلُ على الأتباعِ قبولَ الإبادة.
4- البرمجةُ الذهنيةُ: توجيهُ الوعيِ والسلوكِ
بالإضافةِ إلى التصنيفِ، تعملُ اللغةُ على برمجةِ الوعيِ الإنسانيِّ بشكلٍ عميقٍ من خلالِ:
-
ربطُ الأفكارِ بالمشاعرِ: الكلماتُ التحوليةُ الثورية لا تخاطبُ العقلَ فقطُ، بلْ تثيرُ مشاعرَ قويةً مثلَ الغضبِ، الأملِ، والانتماءِ. فمثلاً: “البروليتاريا” تثيرُ شعوراً بالظلمِ المشتركِ. “الرأسمالية” تثيرُ شعوراً بالغضبِ على الاستغلالِ. “العرقُ النقيُّ” يثيرُ شعوراً بالفخرِ والتفوقِ، وهذه نقطة وعنصر في غاية الأهمية لأنه من خلاله بالإمكان أن تتجلى كثير من الحقائق التي تلبست ثوباً آخر من خلال تلكم التأطيرات اللغوية.
-
تبسيطُ الواقعِ المعقدِ: تقدمُ اللغةُ التحوليةُ الثورية تفسيراتٍ بسيطةً ومقنعةً لأزماتٍ معقدةٍ. بدلاً منْ تحليلِ الأسبابِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ المتعددةِ للمشكلاتِ، فإنها تُرجعُ كلَّ شيءٍ إلى سببٍ واحدٍ مبسطٍ (الرأسماليةِ، أو عرقٍ معينٍ)، مما يسهِّلُ على الجماهيرِ فهمَ المشكلةِ وتوجيهِ غضبها نحو هدفٍ محدد وهذه فيها من المخاطر ما فيها على هذا النحوٍ.
-
خلقُ الأيديولوجيا: الكلماتُ ليستْ منفردةً، بلْ تتجمعُ في منظومةٍ فكريةٍ متكاملةٍ (أيديولوجيا) تقدمُ رؤيةً شاملةً للعالمِ. هذهِ المنظومةُ تحددُ ما هوَ “حقٌ” وما هوَ “باطلٌ”، وتملي على الأتباعِ طريقةَ تفكيرِهم وتصرفاتِهم.، وأخطر ما فيها حينما تعمل على التأطير المخل الذي ينفي الآخر، وهذه تكون صورها من خلال سياقات اجتماعية وأعراف تستمر بالنمو من خلال الإمداد المقصود، خيراً كانت أم شراً.
مشروع اللغة العالمية الإنقاذية – خريطة الطريق
و التصميم الشامل
إنَّ الحلَّ الجذريَّ لهذهِ الأزمةِ اللسانيةِ يكمنُ في تطويرِ “اللغةِ العالميةِ الإنقاذيةِ” التي تحملُ في بنيتها الشفرةَ الجينيةَ لِحَضارةٍ سليمةٍ. إنَّ هذا المشروعَ لا يهدفُ إلى فرضِ لغةٍ واحدةٍ على العالمِ، بلْ إلى توفيرِ لغةٍ “إضافيةٍ“ تكونُ لغةً للتواصلِ العلميِّ والثقافيِّ، لها خصائص مركبة على المستوى العلمي والأخلاقي والقيمي والنظام العقلي الأمثل، وهي لغةً للوعيِ والتربية، ولعلها ستكون العربية.
-
الرؤية الاستراتيجية العامة
الهدفُ النهائيُّ هوَ أنْ تُصبحَ هذهِ اللغةُ لغةً عالميةً، قادرةً على:
-
تجاوزِ سوءِ الفهمِ: من خلالِ وضوحها الدلاليِّ المطلقِ، الذي يجعلُ كلَّ كلمةٍ تحملُ معنىً واحدًا دقيقًا.
-
توحيدِ الفكرِ: من خلالِ بنيةٍ نحويةٍ تُعكسُ الحقيقةَ، وتُشجعُ على التفكيرِ المنطقيِّ والإبداعيِّ.
-
تغذيةِ الروحِ: من خلالِ جمالها الفطريِّ وإيقاعِها المتوازنِ الذي يُطَمئِنُ النفسَ
2- البنية المؤسسية للمشروع
لِتحقيقِ هذهِ الرؤيةِ، يجبُ بناءُ بنيةٍ مؤسسيةٍ قويةٍ، تُشبهُ في هيكلها المؤسساتِ التي بنتِ ورسخت اللغاتِ العالميةَ السابقةَ. تتضمنُ هذهِ البنيةُ:
-
المجلس الأعلى للغة العالمية الإنقاذية: يُشبهُ المجمعَ اللغويَّ ولكنهُ عالميٌّ، ويضمُ مفكرينَ وعلماءَ من جميعِ الثقافاتِ لِضمانِ التنوعِ والحيادِ، عملهم النظر في خصائص اللغات ودفعها وترجيحها نحو الفاعلية والإنتاجية المعرفية والقيمية والأخلاقية ولعل مثل هذه الخصائص سنجد العربية لها الحضور والتفوق.
-
معهد تطوير اللغة: يُعدُ مركزًا للبحثِ والتطويرِ، ويجمعُ بينَ اللسانياتِ وعلمِ النفسِ والفلسفةِ لِضمانِ أن تكونَ اللغةُ مبنيةً على أسسٍ علميةٍ ووجوديةٍ سليمةٍ.
-
جامعة اللغة الإنقاذية: هدفُها إعدادُ جيلٍ جديدٍ منَ المتخصصينَ والمُربينَ الذينَ يُفكرونَ بهذهِ اللغةِ ويُعلمونَها.
-
حركة ترجمة واسعة مع مراصد ثقافية: ترصد اتساع العلوم والمعرف لمواكبتها من خلال تأسيسها والبناء والتأصيل معها وعليها.
التحديات والآثار الحضارية – العقبات والتحديات المتوقعة
إنَّ مشروعًا بهذا الحجمِ يواجهُ تحدياتٍ جسيمةً، ليسَ أقلُّها مقاومةُ التغييرِ من قبلِ الأفرادِ، وبعض المؤسسات التي ترى في لغتها مصدرًا لقوتها. من منظورِ الأنثروبولوجيا الثقافيةِ، فإنَّ اللغةَ مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بالهويةِ، وأيُّ محاولةٍ لِتقديمِ لغةٍ بديلةٍ قد يُنظرُ إليها كَـ”غزوٍ ثقافيٍّ”.
لِلتغلبِ على هذهِ التحدياتِ، يجبُ أن تكونَ الاستراتيجيةُ حكيمةً:
-
التدرجُ: لا ينبغي فرضُ اللغةِ كبديلٍ، بلْ كإضافةٍ تُثري الثقافاتِ المحلية.ثم بعد ذلك سنجد العالم هو من يختار اللغة المتفوقة لإنقاذ العلم والعالم والاستجابة للابتكارات التي ما أصبحت تستوعبها اللغات الآنية التي تتصدر العلم الآن.
-
الشفافيةُ: يجبُ أن يكونَ المشروعُ مُتاحًا للجميعِ، وأن تُتخذَ القراراتُ بِمشاركةٍ واسعةٍ، لِتجنبِ شبهةِ الهيمنةِ أو التلاعبِ.
-
التركيزُ على القيمةِ المضافةِ: يجبُ أن تُثبتَ اللغةُ الإنقاذيةُ قيمتَها في مجالاتِ العلومِ والتقنيةِ والفنونِ، لتكونَ مُحفزًا للتبني الطوعي.
الرؤى المستقبلية
إنَّ النجاحَ في هذا المشروعِ سيُؤدي إلى ولادةِ حضارةٍ إنسانيةٍ جديدةٍ، تتميزُ بـ:
-
الوحدةِ في التنوعِ: لغةٌ مشتركةٌ للتفاهمِ، معَ احتفاظِ كلِّ ثقافةٍ بخصوصيتِها.
-
التوازنِ الكونيِّ: انسجامٌ بينَ الإنسانِ والطبيعةِ، وبينَ المادةِ والروحِ.
-
الحكمةِ التطبيقيةِ: المُنتَج من خلال هذه اللغة هو علمٌ مؤسسٌ على الأخلاقِ، وتقنيةٌ صديقةٌ للإنسانِ والبيئة.
إنَّ هذهِ الرؤيةَ ليستْ مُجردَ نظريةٍ، بلْ هيَ دعوةٌ للعملِ الحضاريِّ في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخِ الإنسانيةِ. إنَّ المستقبلَ الذي نصبو إليهِ لنْ يتحققَ بالأحلامِ وحدَها،بلْ يتطلبُ منا جميعاً أنْ نُعيدَ النظرَ في لغتِنا، لِتصبحَ أداةً لبناءِ الواقعِ، لا مُجردَ وصفِهِ. إنها مسؤوليةٌ جماعيةٌ، تتجسدُ في كلِ كلمةٍ صادقةٍ، وكلِ فكرةٍ بَنّاءةٍ، وكلِ خطوةٍ نحو عالمٍ يُتكلمُ فيهِ بلغةِ الحقيقةِ والجمالِ.
