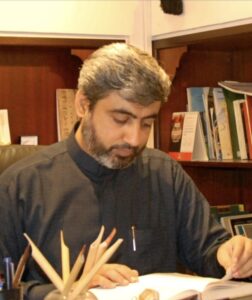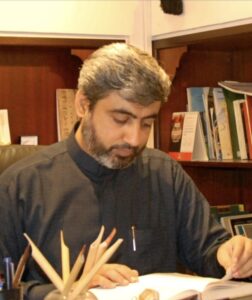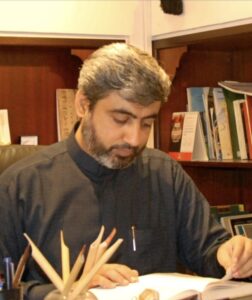
زيد الأعظمي: المفتاح النظري للنهوض والترميم
إن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم – “اقْرَأْ” – لم تكن مجرد أمر إلهي بتعلم القراءة والكتابة،بل كانت انفجاراً معرفياً واتقاداً عظيماً أعاد تشكيل علاقة الإنسان بالكون والوجود والمعرفة. لقد شكّلت هذه الكلمة الواحدة ثورة معرفية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، فهي عملية تشغيل المحركات المعرفية الكامنة في العقل البشري، وإعادة برمجة الوعي الإنساني ليدرك أن كل ما في الكون آية ومعجزة، وأن المطلوب ليس انتظار معجزة حسية خارقة،بل إعادة قراءة المعجزات الدائمة المبثوثة في كل ذرة من ذرات الوجود.
في سياق الخلق: دعوة لإعادة النظر في المنتظمات الكونية
جاء الأمر الإلهي “اقْرَأْ” في سياق دلالي بالغ العمق، حيث اقترن مباشرة بالحديث عن الخلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾. هذا الترابط العضوي بين القراءة والخلق ليس عرضياً، بل يحمل دلالة حضارية محورية: “اقرأ” هنا تعني أعد النظر في كل شيء. إنها دعوة لإعادة قراءة الكون بعيون جديدة لا تألفه، والخلق بعقل يتساءل لا يسلّم، والقوانين بفكر يبحث لا يستسلم، والذات الإنسانية بوعي يدرك عظمة الخالق في دقة المخلوق. إن “اقرأ” في سياق الخلق تعني تأمل في آيات الله المنظورة – الكون والطبيعة والإنسان – قبل أو مع قراءة آياته المكتوبة في القرآن. إنها دعوة لإعادة تشغيل المنظومة المعرفية والفكرية التي تبلدت بفعل الألفة والعادة.
المعجزات الحسية في الرسالات السابقة: خرق القوانين والإدهاش اللحظي
لقد أُوتي الأنبياء السابقون معجزات حسية مادية كانت تمثل خرقاً للقوانين المألوفة التي اعتادت عليها العقول حتى تبلدت. موسى عليه السلام جاء بالعصا التي تتحول إلى ثعبان خارقة لقانون الجمادات، وبانفلاق البحر خارقاً لقانون السوائل وطبيعة الماء، وباليد البيضاء خارقة لقانون اللون والجسد. عيسى عليه السلام جاء بإحياء الموتى خارقاً لقانون الحياة والموت، وبإبراء الأكمه والأبرص خارقاً لقوانين الطب المعروفة، وبالطير من الطين خارقاً لقانون المادة والحياة. صالح عليه السلام جاء بالناقة من الصخرة خارقة لقانون التكوين الطبيعي.
إن جوهر المعجزة الحسية يكمن في أنها خرق مفاجئ لقانون طبيعي اعتادته العقول، وإدهاش لحظي يصدم الوعي المألوف، واستفزاز للتفكير من خلال كسر المتوقع. فعندما ترى العقول قانوناً جديداً يتحدى قوانين اعتادت عليها حتى تبلدت أمامها – كأن يسير الإنسان على الماء أو ينفلق البحر – فإنها تُصعق وتدهش، ومن خلال هذا الإدهاش تؤمن. لكن هذا الإيمان غالباً ما كان مؤقتاً يزول بزوال المعجزة، وسطحياً قائماً على الإدهاش لا على الفهم، وهشاً سرعان ما تعود معه الأمم إلى وثنيتها وعبثها. والدليل التاريخي واضح: لم تلبث أمم كثيرة – رغم رؤيتها للمعجزات – أن عادت إلى ضلالها وعبثها واختلالها. بنو إسرائيل رأوا انفلاق البحر، ثم عبدوا العجل. قوم صالح رأوا الناقة، ثم عقروها.
لماذا لم نُؤْتَ المعجزات الحسية؟ من الطفولة الحضارية إلى النضج المعرفي
هنا يأتي السؤال المحوري: لماذا لم تُعطَ هذه الأمة معجزات حسية مادية كالتي أُعطيت للأنبياء السابقين؟ الجواب يكشف عن نقلة حضارية عميقة: لم نُؤْتَ المعجزات الحسية المؤقتة، بل أُوتينا “اقْرَأْ” – المعجزة المعرفية الدائمة. إن المعجزات الحسية المادية كانت تمثل مرحلة الطفولة في عقلية الشعوب والأمم. فالطفل لا يفهم إلا الملموس المحسوس، ولا يقتنع إلا بالإدهاش البصري، ولا يثبت على موقف طويلاً. كذلك كانت الأمم السابقة في مرحلة طفولة حضارية: تحتاج إلى الصدمة الحسية لتؤمن، وتتحرك بالإدهاش اللحظي، ولا تلبث أن تنسى وتعود.
أما هذه الأمة، فقد أُريد لها أن تدخل مرحلة النضج الحضاري. لا تعتمد على الإدهاش اللحظي، بل على الاكتشاف المستمر. لا تنتظر خرق القوانين، بل تكتشف القوانين وتستخدمها. لا تتلقى المعجزة جاهزة، بل تصنع معجزاتها المعرفية. لذلك كانت معجزتها نصاً يُقرأ – القرآن الكريم، وعقلاً يُفعَّل – “اقرأ”، وكوناً يُكتشف – “الَّذِي خَلَقَ”.
فلسفة الألفة: إعادة اكتشاف المعجزة الدائمة في الكون
إن أعظم ما يُفقد الإنسان الدهشة والإدراك هو الألفة والعادة. فحين يرى الإنسان شيئاً كل يوم، يفقد القدرة على رؤية إعجازه. ولنتأمل هذه التجربة الفكرية العميقة: لو أن انفلاق البحر في زمن موسى عليه السلام تكرر كل يوم، والناس تراه صباحاً ومساءً – ماذا سيحصل؟ سيحصل في النفس البشرية ما حصل معها حينما ترى السماء التي تُمسك بلا عمد، والشمس التي تسير بنظام دقيق لا تتأخر ولا تتقدم، والقمر الذي يتبدل منازله بدقة رياضية، والنبات الذي يخرج من الأرض الميتة، والثمار المتنوعة من ماء واحد وتربة واحدة، والحيوان والطير بتنوعها المدهش وغرائزها المعقدة، والإنسان نفسه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى خلق آخر.
كل هذه معجزات دائمة، لكن الألفة أفقدتها دهشتها. لو نظر الإنسان إلى انبثاق الشمس كل صباح بنفس الدهشة التي ينظر بها إلى انفلاق البحر، لأدرك أن الأولى أعظم وأدق. لو تأمل في خلية واحدة من جسده – فيها ثلاثة مليارات حرف من الشفرة الوراثية تعمل بتنسيق خارق – لوجدها لا تقل إدهاشاً، بل تفوق كثير من المعجزات. هنا تأتي “اقرأ” لتقول للإنسان: أعد قراءة ما أَلِفْتَ، انظر إلى الكون بعيون جديدة، تأمل في الخلق كأنك تراه لأول مرة. إن “اقرأ” هي محرك لإعادة النظر في كل ما اعتدنا عليه، وإعادة التفكر في كل ما تبلدنا أمامه، وإعادة الدهشة أمام كل ما صار عادياً.
إن الفكر والعقل والنفس يحتاج إلى إعادة تشغيل المنظومة المعرفية والفكرية ليجد أن كل ما خلق الله ربما أشد إدهاشاً وإعجازاً من معجزات حصلت من قبل. فانفلاق البحر معجزة عظيمة حدثت مرة واحدة، لكن نظام الدورة الدموية في جسدك يحصل كل ثانية، وانقسام الخلايا بدقة متناهية يحصل كل لحظة، والتوازن البيئي في الأرض يُحفظ كل يوم، وجاذبية الأرض التي تمسكنا لا تتوقف لحظة. هذه معجزات دائمة، لكننا لم نُعد نراها. “اقرأ” جاءت لتقول: أعيدوا اكتشاف المعجزة في اليومي والمألوف.
المسار المعرفي للإبداع الحضاري
إن “اقرأ” في سياق الخلق ليست دعوة للتأمل السلبي فقط، بل دعوة للنظر والتفكر في المرحلة الأولى – رصد الظواهر كما قال تعالى “أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ” و”قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ”، ثم للبحث والاكتشاف في المرحلة الثانية – استكشاف القوانين كما قال “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ”، ثم للتطبيق والابتكار في المرحلة الثالثة – استخدام القوانين كما قال تعالى : “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا”. إن المسار المعرفي يبدأ بـ “اقرأ” (تأمل)، ثم اكتشف قانوناً جديداً، ثم اجمعه مع قوانين أخرى، ثم ابتكر حلولاً جديدة، ثم أبدع نماذج حضارية.
لنتأمل مثالاً تطبيقياً: التأمل في طيران الطيور (اقرأ) يقود إلى اكتشاف قانون الديناميكا الهوائية، وجمعه مع قوانين الفيزياء والهندسة يقود إلى ابتكار الطائرة، ثم إبداع صناعة قوانين طيران جديدة ومتقدمة . هذه هي “المعجزة المبرمجة” – ليست خرقاً للقوانين، بل إتقاناً لاستخدامها. وهنا يتضح لنا لماذا “اقرأ” أرسخ من المعجزة الحسية في أربعة أبعاد محورية.
أولاً، في الوعي الإنساني: المعجزة الحسية تُدهش لحظة ثم تُنسى، بينما “اقرأ” تُنتج معرفة تتراكم وتُورث عبر الأجيال. ثانياً، في الفاعلية البشرية: المعجزة الحسية يشاهدها الإنسان سلبياً كمتفرج، بينما “اقرأ” يشارك فيها الإنسان إيجابياً كباحث ومكتشف ومبتكر. ثالثاً، في الثبات الأممي: المعجزة الحسية جعلت أمماً آمنت لحظة ثم ارتدت، بينما “اقرأ” بنت أمة حضارة استمرت قروناً ولا تزال قابلة للبعث. رابعاً، في الرقي الحضاري: المعجزة الحسية لا تُنتج علماً ولا حضارة، بينما “اقرأ” أنتجت أعظم حضارة علمية عرفها التاريخ.
ثنائية البناء الحضاري المستدام
لكن “اقرأ” وحدها قد تُنتج علماً، أما مع منظومة التوحيد فإنها تُنتج حضارة متزنة راسخة. التوحيد يضمن وحدة الهدف – فالعلم لله لا للطغيان، ووحدة الأخلاق – فالبحث بأمانة لا بغش، ووحدة الغاية – فخدمة الإنسان لا استعباده. إن “اقرأ” بلا توحيد قد تنتج القنبلة الذرية والأسلحة البيولوجية والاستعمار العلمي، أما “اقرأ” مع التوحيد فتنتج الدواء والعمران والحضارة الإنسانية. هذا هو الفرق بين علم بلا ضمير وعلم بضمير، بين معرفة تخدم القوة ومعرفة تخدم الإنسانية.
إن المقارنة بين نموذج المعجزة الحسية ونموذج “اقرأ” مع التوحيد تكشف عن فروق جوهرية. من حيث الطبيعة: الأولى إدهاش لحظي والثانية اكتشاف مستمر. من حيث الديمومة: الأولى مؤقتة تنتهي بموت النبي والثانية دائمة تتراكم عبر الأجيال. من حيث الدور البشري: الأولى سلبي كمشاهد والثانية إيجابي كباحث ومبتكر. من حيث الأثر الحضاري: الأولى ضعيف لا ينتج علماً والثانية قوي ينتج حضارة علمية. من حيث الثبات الإيماني: الأولى هش سرعان ما يزول والثانية راسخ قائم على فهم. من حيث مرحلة التطور: الأولى تمثل طفولة حضارية والثانية تمثل نضجاً حضارياً.
في سياق هذه الرسالة حول الاتقاد والترميم الحضاري، فإن فهم “اقرأ” كثورة معرفية ونقلة نموذجية من الإدهاش اللحظي إلى الاكتشاف المستدام يشكل المفتاح النظري لفهم آليات متعددة. فمن جهة، كانت “اقرأ” الشرارة الأولى التي أشعلت المحركات المعرفية في أمة أمية، فانطلقت في قرون قليلة لتُنير العالم بالعلم والحضارة – وهذا هو الاتقاد الحضاري الأول. ومن جهة أخرى، كلما أصاب الأمة خمود حضاري، فإن العودة إلى “اقرأ” بمعناها الشامل – قراءة النص والكون والواقع – هو مفتاح إعادة الإشعال، وهذا هو الترميم الحضاري المتكرر. ومن جهة ثالثة، فإن حضارة تقوم على “اقرأ” مع التوحيد لا تموت، بل قد تخمد ثم تُعاد إشعالها كلما تحققت شروط الاتقاد، وهذه هي ضمانة الاستدامة الحضارية.
إن النموذج الحضاري الإسلامي – القائم على المعجزة المعرفية الدائمة لا المعجزة الحسية المؤقتة – يمثل نقلة نوعية في تاريخ الحضارات: من الطفولة إلى النضج، ومن السلبية إلى الفاعلية، ومن الإدهاش إلى الاكتشاف، ومن اللحظي إلى المستدام. إن “اقرأ” ليست مجرد أمر بالقراءة، بل هي إعلان ميلاد نموذج حضاري جديد – نموذج لا ينتظر المعجزات الخارقة، بل يصنع معجزاته المعرفية من خلال القراءة والبحث والاكتشاف والابتكار. إنها إعادة تشغيل للوعي الإنساني ليدرك أن كل ما خلق الله آية ومعجزة، وأن المطلوب ليس خرق القوانين، بل اكتشافها واستخدامها.
وحين نفهم أن الاتقاد الحضاري ليس حدثاً عفوياً، بل نتيجة تفعيل “اقرأ” في كل أبعادها – قراءة النص وقراءة الكون وقراءة الواقع – فإننا نكون قد وضعنا أيدينا على المفتاح الأساسي لفهم آليات النهوض والترميم والاستدامة الحضارية. هذه هي المقدمة التمهيدية التي تؤسس لعلاقة عضوية بين المنهج المعرفي القرآني – اقرأ – وبين نظرية الاتقاد والترميم الحضاري التي تقوم عليها هذه الرسالة. إن “اقرأ” مع منظومة التوحيد تمثل أرسخ حالة في الوعي الإنساني والفاعلية البشرية والثبات الأممي والرقي الحضاري، وهي البوابة الذهبية لفهم كيف تُشعل الأمم جذوة حضاراتها، وكيف تُرمّم ما تصدع منها، وكيف تضمن استدامتها عبر الأجيال.