السرد من المأساة الفردية إلى البنية الرمزية للمكان والزمان
التماهي مع السادية من أكثر الظواهر النفسية غموضًا
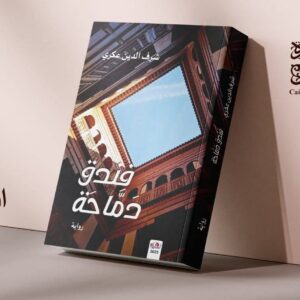

شرف الدين عكري

قراءة : رجاء بسبوسي
في تقاطع للحكايات ضمن الحكاية نفسها، ومن خلال بنية زمنية تتجاوز التسلسل الخطي التقليدي للأحداث، يقدم المنجز السردي “فندق دماحة” للكاتب المغربي شرف الدين عكري، معالجة موضوعية لموضوعة العبودية والنخاسة في المغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. يكشف المتن عن جانب مظلم من التاريخ الاجتماعي المغربي عبر قصة الفتاة دمّاحة، التي كانت تعيش بسلام وطمأنينة في إحدى واحات الجنوب الشرقي للمغرب، قبل أن يتم اختطافها من الواحة وبيعها في “سوق الغْزل” بمدينة مراكش مع أخريات من ذوات البشرة السمراء، لتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد انتقالها إلى دار “سِيدْ العابْد” ، حيث ستدخل عالم الإماء والخادمات، وتختبر مرارة الاستعباد والانتهاك الجسدي والنفسي في رحلة سردية تكشف وجها من وجوه القسوة والظلم الاجتماعي.
ومن خلال هذا الامتداد الحكائي، ينتقل السرد من المأساة الفردية إلى البنية الرمزية للمكان والزمان، إذ يتحول بيت سِيدْ العابْد إلى مسرح للسيطرة والاستعباد، فيما يعكس حاضر دمّاحة حياتها بعد العبودية وتجربة الانكسار والانتهاك الذي عاشته. بهذا التوظيف المكاني والزماني، ينجح النص في تجسيد آليات السادية كمنظور نفسي واجتماعي، تتجلى في شخصية سِيدْ العابْد التي تمثل السادية في أقسى صورها، فهو يجسد الميل أو النزعة التي يحصل فيها الشخص عن لذة أو إشباع نفسي (وأحيانا جنسي) من خلال إلحاق الألم أو الإذلال بالآخرين، كما يوضح الطبيب النفسي الشرعي النمساوي ريتشارد فون كرافت-إيبينغ في كتابه الشهير Psycopathia Sexualis الصادر عام 1886، وبهذا المعنى فإن السادية تمثل تفاعلًا معقدًا بين العدوان واللذة، فالسادي لا يسعى إلى الإيذاء بدافع الغضب أو الدفاع عن النفس، بل من أجل التمتع بالشعور بالقوة والسيطرة، وهي الدينامية التي تضيء خلفية العنف الاجتماعي في السياق المجتمعي الذي تصوره الرواية.
إذا صح أن “نيرون” أشعل النار في روما ليستمتع بمشهد احتراقها وهو يعزف على قيثارته، فإن هذا المشهد المفعم بالنزعة السادية يوازي في الرواية موضوع الدراسة صورة سِيدْ العابْد وهو يعزف على العود بنشوة قاسية، بعد أن أمر عبده مْبيريك بجلد دمّاحة العارية دون أدنى رحمة، في تجسيد صارخ لتغلغل السادية في أعماق شخصيته..”اجلدها! اجلدها بعنف أكبر! بعنف أكبر وإلا سلخت جلدك أنت الآخر! وراح يعزف مغمض العينين، متلذذا بأنين “دماحة” الممزوج بنغم العود، وخرير مياه النافورة، وصوت السوط! “ ص 197. إن هذا المشهد المروع لا يقل وحشية عن مشهد آخر أكثر فظاعة، حين يصور لنا الكاتب عمق التوحش السادي في شخصية “سِيدْ العابْد”، وهو يأمر عبده “مْبيريك” وجواريه بحمل “دمّاحة” الفاقدة الوعي إلى غرفته لاغتصابها، فيما كانت قطرات الدم تسيل منها دون انقطاع جراء الجلد، قبل أن يصيح فيهن آمرا أن يزغردن وأن لا يتوقفن عن ذلك إلى أن يغادر الغرفة. “والآن زغردن! ولا تتوقفن عن ذلك حتى أخرج! | فانطلقت الزغاريد تلعلع في الهواء كأنها طلقات بارود! ولم تتوقف حتى خرج “سيد العابد” ، وأمر بذلك، فسار يتبختر في مشيته كأنه طاووس باتجاه الحمام. “ ص 199-200.
إن شخصية “سِْيد العابْد “وإن مثلت التجسيد الذاتي للسادية في الرواية، فإن هناك تمظهرًا مجتمعيًا آخر لها يتمثل في التطبيع مع فكرة الاستعباد، بل وفي ممارسات قاسية جرى تقبلها وكأنها أمر طبيعي، مثل إخصاء العبيد الذين يسمح لهم بالبقاء في البيوت إلى جانب نساء الدار. ويعد العبد “مْبيريك” أبرز تجسيد لهذا البعد في المتن الروائي. “أحنى بصره وقال بتشظ: أنا رجل معطل الرجولة.” ص 158. “أنا رجل مخصي (…) تم ذلك تحت إشراف السيد الأول الذي اشتراني، (…) وسمح لي بالاختلاط مع حريمه بكل اطمئنان ص 214.
إذا كانت نزعة السادية تنبع من دوافع نفسية عميقة لدى الشخصية، فإن التماهي مع هذه النزعة يعد من أكثر الظواهر النفسية تعقيدا وغموضا. وتشكل علاقة العبد بسيده القاسي مثالًا جليًا على آلية التماهي مع المعتدي، حيث يذوب المقهور في صورة القاهر حتى يفقد وعيه بحدود ذاته واستقلاله.
في هذ السياق تبدو “دمّاحة” الشخصية الوحيدة التي رفضت هذا النمط من العلاقة، متمسكة بكينونتها الإنسانية وحريتها الداخلية، حيث تقول في المتن: “لن أركن، ولن أقنع بهذا القدر اللئيم أبدا، ولن أكتفي بالتفرج. لا محبة ممكن أن تقوم بين السيد والعبد، الأول قاهر والثاني مقهور، فكيف يستقيم الشعور في مثل هكذا وضع؟ كيف؟” ص 151. في المقابل انخرط بقية العبيد في التماهي مع سيدهم، وعلى رأسهم العبد مْبيريك والجارية دادا مْسيعيدة. ولا يعرض النص مشاهد الرهبة والخضوع الأولى التي يمر بها العبد قبل أن يبلغ مرحلة التماهي، بل يقدم لنا هـٰتين الشخصيتين وقد استقرتا في تلك المرحلة المتقدمة من الارتباط بالمعتدي، حيث يتحول الخوف إلى ولاء والدونية إلى تبرير للعنف كما جاء في النص: “لقد فهمتْ المنظومة التي يمثلها “سيد العابد” و”مسيعيدة” وغيرهما، منظومة السيد والعبد المتماهي معه كليًا والمدافع عنه أبدًا” ص 133. “غرقت دمّاحة، تفكر فيها وفي مبيريك وبقية الفتيات، وتتساءل كيف حدث وتقبلوا وضعهم! لقد استفزها ما بدا على وجوههم جميعا من معالم الفرح لحظة الترحيب بعودة سيد العابد سالما من سفره” ص 136.
وفيما يخص العبد مْبيريك فلقد تجلى تماهيه منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها قدما دمّاحة دار سِيدْ العابْد إذ استقبل سيده بضراعة وخشوع وولاء مطلق: ” -لا حرمنا الله منك، ومن طلتك المشرقة. رد مبيريك بما يشبه الخشوع، فدنا من سيد العابد، قبل كتفه الأيمن أولا، ونزع عنه برنسه ثانيا” ص 125. “قال مبيريك ذلك فانسحب راكضا، والفرحة تقطر من أطرافه” ص 126. ويبلغ هذا الخضوع ذروته حين يصبح الانمحاء أمام السيد فعلا داخليا نابعا من قناعة راسخة: ” يكفي أنك تعلم من يرقد تحت ترابهم يا سيدي، ويكفي أنك تبجلهم لأفعل” ص 184.
أما الأمة “دادا مْسيعيدة”، التي كانت أداة في يد سيدها “سِيدْ العابْد” لتدجين الجواري، فيكشف النص عن بلوغها مرحلة متقدمة من التماثل مع السيد مقارنة بالعبد مْبيريك ، فقد وجدت في خدمتها للسيد وزوجته لالة كنزة مصدر دفء وطمأنينة، حتى غدت ترى في تلك الحياة نعمة إلـٰهية: “ولم أعرف مكانا أدفأ من دار سيد العابد، فهنا عاش والداي يسهران على خدمة آباء سيد العابد، وهنا أعيش وأسهر على خدمة سيد العابد ولالة كنزة وأبنائهم، وإنني أشكر الله تعالى أن جعلني أحيا هنا” ص 148. ويتعزز هذا التعلق في قولها: “عوضني سبحانه وتعالى بأن زرع محبة أبناء سيد العابد في قلبي. إنهم أبنائي جميعًا، وبدون استثناء. أنا من ربيتهم، حملتهم فوق ظهري، وضممتهم بين أحضاني، دون أن أتعب هنيهة أو أتذمر أو أشعر بالملل.” ص 147.
هذه الأقوال لا تدل على أن “دادا مسيعيدة” لم تعد ترى نفسها جارية، بل على العكس، فهي واعية تمامًا بموقعها التابع داخل بنية السلطة والخدمة، غير أنها تتبنى هذا الموقع وتتماهى معه حتى العبودية الطوعية: “السيد هنا هو سيد العابد، نحمل أوامره ونواهيه وتتشربها عروقنا. والسيدة هي لالة كنزة ، تصدر الأوامر ونحن نتكلف بكل شيء” ص 132.
إن هذا التماهي العميق مع الأسياد هو ما جعل “دادا مسيعيدة” تستنسخ القهر ذاته الذي مورس عليها، حين مارسته بدورها على “دمّاحة” التي حاولت المساومة من أجل حريتها، وفي المقابل يظهر العبد “مْبيريك” في موضع مختلف، إذ رغم خضوعه الظاهر، ظل في أعماقه رافضا لحياة المهانة التي فرضت عليه، كما يعترف بذلك في الفصل الأخير من الرواية: “حياة قتلني الاعتياد عليها، فاستسلمت أتفرج على انفراط حبات عقدها من بين يديّ! حياة لفحتني بلهيبها ولفتني بضبابها، فكتمت أنفاسي وأورثت في روحي المهانة!” ص 215.. “لم أعش إلا تحت ظل أسيادي، ولم آكل إلا فتاتهم، ولم أفرح إلا من أجلهم، ولم أحزن إلا عليهم!” ص 216.
وهكذا يبرز هذا المنجز السردي المفارقة بين شخصيتين خضعتا للعبودية، غير أن الأولى أعادت إنتاجها بوصفها اقتناعًا وجوديًا، بينما الثانية عاشتها جرحًا لا يلتئم وانتفضت عليها بطريقتها الخاصة.
إن رواية “فندق دمّاحة” لا تقتصر على استحضار وقائع العبودية في بعدها التاريخي، بل تتخطى ذلك إلى مساءلة البنى العميقة للقهر التي ما تزال تتخفى في راهن الإنسان تحت أقنعة رمزية ونفسية جديدة. فمن خلال تحليل نزعة السادية وتجليات التماهي مع المعتدي، تكشف الرواية عن آليات السلطة والهيمنة المتغلغلة في العلاقات الإنسانية، مسلطة الضوء على أكثر الظواهر النفسية غموضا وتعقيدا. وهكذا تتحول تجربة دمّاحة من حكاية عن العبودية إلى غوص في جوهر الحرية، فبينما ترضخ الشخصيات الأخرى لمنطق القهر، تختار دمّاحة فعل المقاومة. إن هذا الوعي الذي تحمله دمّاحة يجعل من النص عملا أدبيا يتجاوز حدود السرد التاريخي ليغدو نقدا عميقا لبنية السلطة بغض النظر عن البعد الزماني والمكاني، وحفرا للبحث الدائم عن إنسان لم تعد العبودية بأشكالها الجديدة قادرة على تدجينه.


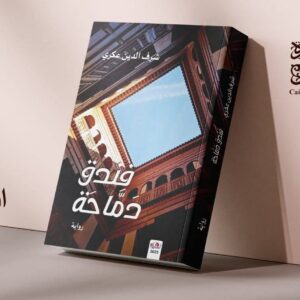


تحياتي واحترامي وان التحليل النقدي للرواية المذكورة قائم على عوامل نفسية تبحث عن العمق الانساني وعن ان الله خلق الانسان حراباختياراته وكرمه وسخر الطبيعة الغير واعية والغير عاقلة لخدمته .وادعم الرواية ذات الدلالات العميقة والباحثة عن الخلاص الانساني وادعم هذا النقد السلس الذي يدل على رجاحة عقل الناقدة .يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) صدق الفاروق الذي فهم حكمة الخالق عز وجل .مع المحبة والاحترام والتقدير وهذه كتابة مهمة وحساسة ويجب ان يسلط الضوء على الكاتب والناقدة من وجهة نظري تحياتي .مهند الشريف
تحية عطرة أستاذي الفاضل.. ممتن جداً لكرمك ونبلك ومشاعرك الطيبة 🙏
الأستاذ الفاضل مهند الشريف،
تحياتي وتقديري العميق لكلماتكم النبيلة، ولنفَسِكم الإنساني الرفيع في قراءة المقال. إن استحضاركم للبعد النفسي ولحكمة الخالق في خلق الإنسان حرًّا مكرّمًا، يضيء المساحة التي سعت الرواية لكشفها، ويمنح النقد بعده الأخلاقي الذي يليق به.
أعتزّ كثيرًا بقولكم الكريم حول رجاحة التحليل، فهو شهادة ثمينة من قارئ يمتلك حسًّا إنسانيًا وبصيرة نقدية تلتقط جوهر النص وقيمته. كما أن استدعاءكم لقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسّخ الفكرة الجوهرية التي ينطلق منها كلّ بحث عن الخلاص الإنساني: الحرية بوصفها أصل الإنسان ومبتدأ كرامته.
أشكركم على دعمكم السخيّ، وتقبلوا تقديري واحترامي الكبير لكم.
قراءة تحليلية اعتمدت في فحص المنجز بين يديها على الجانب النفسي للشخصيات بنوعيها، الحاكمة والمحكومة أو المالكة (قهرا) والمستعبدة (غصبا وعن طواعية)، داخل فضاءات تختنق بأشكال الاستغلال وأمكنة وإن اختلفت يبقى القاسم المشترك بينها تكريس صور التفاوت الطبقي والكشف عن ألوان الظلم الاجتماعي.
تحليل غاص في شخصية الحاكم ليكشف ساديته وانحرافه الفكري والخلقي، والذي من الطبيعي أن تكون أفعاله الجرمية خادمة لمصالحه ونزواته كونه الطرف المستفيد؛ لكن الغريب ووفقا لما ألمع إليه التحليل هو قبول فئات محكومة للظلم والعذاب واستساغته بل واستعذابه، سواء منه العذاب الواقع بها أم بغيرها، كما أنها تشرعن له وتجعله حقا موكولا لسيدها ممارستُه، في حين أن حقها هي أن تقبل به، تماما كما توارثته وكما ستورثه.
والطبيعي كما أراني أستشف من هذا التحليل الرغبة في التصريح به، هو رفض الاستعباد والظلم الممارس عليها بكل ألوانه، والتوق إلى الانعتاق لتحيا حرة كما ولدت حرة، وهي حال الشخصية البطل “دماحة”.
قراءة كاشفة بقلم أنيق انبرى بمهارة للكشف عن مضامين المُنجز الصريحة منها والمضمرة، من جهة، ومن جهة أخرى، يستفز القارئ ويحفزه لقراءة ذلك المُنجز “فندق دماحة” مستنيرا بالمنارات النفسية والإشارات المجتمعية لهذه القراءة.